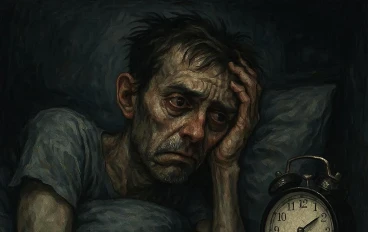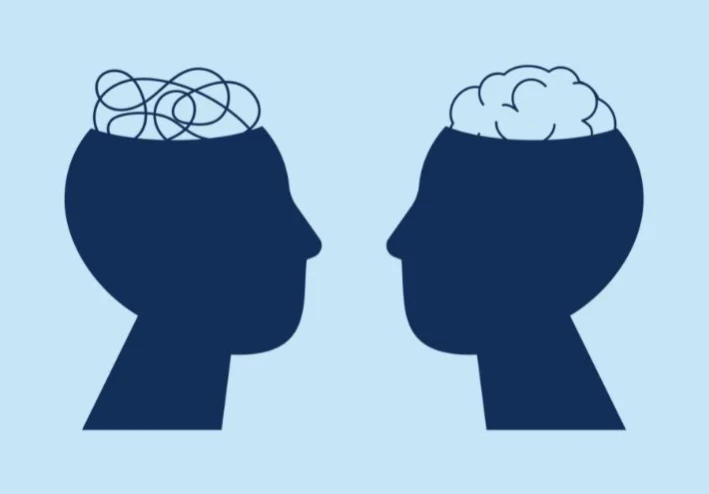
إضطراب الشخصية الفصامية
إضطراب الشخصية الفصامية (Schizoid Personality Disorder): التعريف، الأعراض، الأسباب، والعلاج
إضطراب الشخصية الفصامية هو أحد اضطرابات الشخصية ضمن مجموعة (A) المعروفة بالغريبة الأطوار. يتميز بنمط ثابت من الإنفصال عن العلاقات الإجتماعية وتقيد التعبير العاطفي في المواقف التفاعلية، ولا يجب الخلط بينه وبين الفصام (Schizophrenia) أو الشخصية الفصامية النمطية (Schizotypal)؛ فالمصاب هنا لا يعاني عادة من أوهام أو هلوسات، وإنما يفضل العزلة ويجد صعوبة في إظهار المشاعر أو بناء علاقات وثيقة.

ما هو اضطراب الشخصية الفصامية؟
هو إضطراب مزمن يبدأ غالبا في بداية البلوغ، يظهر في صورة لامبالاة إجتماعية وبرود عاطفي نسبي ويميل المصاب إلى الأنشطة الفردية، ويبدو غير مبال بالمدح أو النقد، ويرى العلاقات القريبة مرهقة أو غير ضرورية.
السمات الأساسية:
1- تفضيل دائم للأنشطة والهوايات الفردية.
2- دائرة علاقات ضيقة جدا (وقد تقتصر على الأسرة المباشرة).
3- تعبير عاطفي محدود: لغة جسد صامتة، نبرة محايدة، صعوبة إظهار الفرح أو الحزن.
4- لامبالاة نسبية بالمدح أو الإنتقاد.
5- متعة منخفضة: (صعوبة الشعور بالمتعة في الأنشطة الإجتماعية).
الفرق عن اضطرابات متشابهة:
الفصام: يشمل أعراضا ذهانية (هلوسات/أوهام)، وهي ليست سمة أساسية هنا.
الفصامية النمطية: تتضمن أفكارا غريبة وتبددا في الإدراك؛ المصاب بالشخصية الفصامية لا يتبنى عادة معتقدات غريبة.
القلق الاجتماعي/الشخصية التجنبية: الدافع الرئيس هناك الخوف من التقييم السلبي؛ أما هنا فالدافع الأساسي الرغبة الأصيلة في الانفراد وضعف الحاجة للمخالطة.
أسباب اضطراب الشخصية الفصامية:
لا يوجد سبب واحد قاطع، بل تتفاعل عوامل متعددة:
1- عوامل وراثية/عصبية:
أ- قابلية وراثية مرتبطة بطيف اضطرابات المجموعة (A).
ب- فروق محتملة في أنماط المكافأة العاطفية والدوائر العصبية المنظمة للتواصل الإجتماعي.
2- عوامل نفسية-مزاجية:
سمات مزاجية مبكرة مثل الإنطواء الشديد، وانخفاض البحث عن التحفيز الإجتماعي، وقدرة محدودة على تمييز المشاعر (alexithymia).
3- عوامل بيئية:
أ- تاريخ من التواصل العاطفي الفقير داخل الأسرة، أو غياب النماذج الداعمة للتعبير الوجداني.
ب- خبرات مبكرة عززت الإعتماد على الذات وتجنب التفاعل.
الأعراض والمعايير السريرية:
1- مؤشرات سلوكية:
أ- قلة الرغبة أو الاستمتاع بالعلاقات القريبة، بما في ذلك الأسرة (إلا حدود عملية).
ب- إختيار متكرر لأنشطة فردية (القراءة، البرمجة، الألعاب الفردية…).
ب- إهتمام محدود بالتجارب الجنسية أو العاطفية مع الآخرين.
ج- متعة منخفضة في معظم الأنشطة الإجتماعية.
د- غياب الأصدقاء المقربين خارج نطاق الأقارب من الدرجة الأولى.
ه- عدم الإكتراث المبالغ فيه بانتقادات أو مديح الآخرين.
و- برود أو تسطح وجداني.
2- الخبرة الداخلية:
أ- شعور بالراحة مع العزلة والإستقلالية العالية.
ب- حاجة منخفضة للتواصل العاطفي، مع صعوبة تسمية المشاعر.
ج- توتر خفيف في المواقف الإجتماعية المزدحمة، لكنه ليس خوفا من الحكم بقدر ما هو نفور من القرب العاطفي.
تشخيص تفريقي (للتفريق عن حالات أخرى)
طيف التوحد (ASD): قد يتشابه في العزلة، لكن ASD يتضمن صعوبات جوهرية في التواصل غير اللفظي وسلوكيات نمطية مبكرة وواضحة.
الشخصية التجنبية: رغبة داخلية في القرب تعوقها مخاوف الرفض؛ في الفصامية الرغبة في القرب ضعيفة أصلا.
الإكتئاب: قد يخفض الإهتمام الإجتماعي مؤقتا، لكن في الفصامية النمط ثابت مزمن منذ البلوغ.
التشخيص عملية إكلينيكية متخصصة تتطلب مقابلة مفصلة واستبعاد أسباب أخرى.
التأثير على الحياة اليومية:
1- المجال المهني: ينجح كثيرون في وظائف تتطلب تركيزا فرديا (بحث، تحليلات، أعمال تقنية)، وقد يواجهون صعوبات في الأدوار القائمة على البيع أو القيادة أو العمل الجماعي المكثف.
2- العلاقات: علاقات قليلة وعملية؛ الشريك قد يفسر الهدوء العاطفي باعتباره رفضا أو برودا.
3- الصحة النفسية: خطر الإكتئاب عند ضغوط الحياة، واحتمال إساءة استخدام مواد للتعامل مع التوتر (أقل شيوعا لكنه وارد).
العلاج والدعم:
1- العلاج النفسي:
أ- العلاج الداعم أو العلاج السلوكي المعرفي المكيف: يركز على التوعية بالمشاعر، وبناء مهارات تواصل بسيطة، وتحديد أهداف اجتماعية واقعية وقابلة للقياس.
ب- تدريب المهارات الإجتماعية: مواقف لعب أدوار (Role-Play) قصيرة، تعليم صيغ افتتاح الحديث، التدرب على التواصل غير اللفظي (نظرة، إيماءة، نبرة).
ج- العلاج الجماعي الصغير البنيوي: قد يفيد إذا كان منخفض الضغط وقواعده واضحة؛ المجموعات الكبيرة العفوية تكون مرهِقة.
2- الأدوية: لا توجد أدوية تعالج الإضطراب بحد ذاته، لكن يمكن علاج الرفيقة المرضية (إكتئاب، قلق) عند الحاجة وتحت إشراف طبي.
3- إستراتيجيات المساعدة الذاتية:
أ- تعريض تدريجي: تحديد تفاعل اجتماعي صغير أسبوعيا (تحية زميل، مكالمة قصيرة).
ب- دفتر مشاعر: تسمية المشاعر يوميا بعبارات بسيطة (مرتاح/مضغوط/محايد) لرفع الوعي الوجداني.
ج- هيكلة الروتين: مزيج من أنشطة فردية محببة + هدف اجتماعي ضئيل ومنتظم.
د- هوايات مشتركة منخفضة الضغط: نادى للقراءة، ورشة قصيرة، لقاءات تقنية صغيرة.
4- دور الأسرة والمحيط:
أ- إحترام الحدود دون تفسير العزلة كرفض شخصي.
ب- دعوات منخفضة الضغط: (لقاء قصير، مساحة هادئة، الخروج مبكرا إن رغب).
ج- تشجيع الثناء المحدد: أعجبني شرحك الهادئ لهذا الموضوع بدلا من مديح عام.
متى أطلب المساعدة؟
1- إذا سبب النمط الإجتماعي تعطلا وظيفيا واضحا أو ضيقا داخليا.
2- عند ظهور أعراض جديدة (حزن شديد مستمر، أفكار إيذاء النفس، قلق حاد).
3- إذا واجهت صعوبة في التمييز بين هذه الحالة وحالات أخرى (توحد، تجنبية، إكتئاب).
أطلب تقييما من اختصاصي نفسي/طبيب نفسي لوضع خطة مناسبة.
الخلاصة:
إضطراب الشخصية الفصامية ليس خطأ شخصيا ولا كسلا اجتماعيا، بل نمط شخصية مستقر يتطلب فهما واقعيا وتوقعات مرنة. بالعلاج الموجه والمهارات الصغيرة المتدرجة، يمكن تحسين جودة الحياة والحفاظ على استقلالية تريح المصاب دون أن تعزله تماما عن العالم.